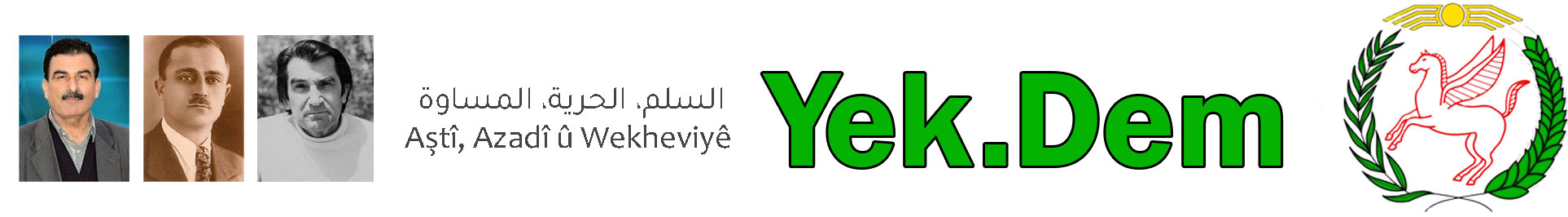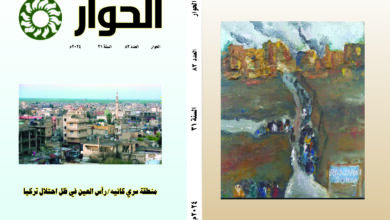مجلة الحوار – جدل – العدد /71/ – السنة 25 – 2018
ثمة جدل ونقاشات حادة لا تجد لها مستقراً على الغالب حول إشكاليات الانتماء والولاء، ومحددات الهوية القومية والوطنية، موضوعنا هنا هو محاولة تسليط الضوء على هذه الإشكاليات لمعالجة ماهية الولاء استناداً للانتماء ووضع أسس صياغة الهوية الوطنية.
مبدئيا الخطأ الخلط بين مفهومي الانتماء والولاء، فالانتماء كينونة يكتسبها الإنسان منذ الولادة، ويعرف بها وتستمر معه حتى مماته، والولاء رغبة اختيارية تحددها مسارات الحياة والمصالح، وتتأثر براهنيتها وواقع حالها.
بشكل أوضح فإن انتماء المرء يكون دوماً لمسقط رأسه أو الأرض التي عاش وترعرع فيها حيث موطنه، والبيئة الاجتماعية التي كونت جزءاً من شخصيته، وحددت لغته وثقافته وبالتالي انتمائه القومي. من جانب آخر وفي الأحوال الطبيعية تحمل الأرض صفة قاطنيها من أقوام وشعوب، وتسمى بأسمائهم وألسنتهم ما لم تتعرض للتغيير قسرياً لاعتبارات سياسية طمعيه أو طموحات عنصرية توسعية.
أما ولاء الإنسان يكون عادةً لحاضنته الاجتماعية كـ (القبيلة أو العشيرة)، والسياسية كـ (المنظمة أو الحزب)، أو الكيان السياسي كـ (الدولة أو الإقليم) الذي يحويه ويضمن حقوقه ويحقق مصالح، فالكرد كشعب ينتمي إلى أرضه التاريخية التي أطلق السلجوقيين عليها اسم كردستان أول مرة(1)، والتي تم تقسيمها بموجب حروب توسعية، و اتفاقيات استعمارية على مراحل بين كلٍ من الامبراطورية القيصرية الروسية (المسيحية) والامبراطورية العثمانية (الاسلامية) من جهة إثر حرب القرم بين الدولتين عام / 1852-1856م/، والامبراطوريتين العثمانية (السنية) و الصفوية (الشيعية) من جهة ثانية إثر معركة جالديران /1514م/، وما تبعتها من اتفاقات (قصر شيرين، أرضروم)(2) التي قسمت الكرد أرضاً وشعباً بين الإمبراطوريات المذكورة (الروسية، العثمانية، الصفوية)، وانتهاءً باتفاقية سايكس- بيكو سنة /1916م/(3) التي وضعتها القوتين العظمتين حينها (بريطانيا و فرنسا)، وما تبعها من قرار ضم ولاية الموصل إلى العراق، والترسيم النهائي للحدود بين الدول الناشئة حديثاً بموجب تلك الاتفاقية التي قسمت كردستان التابعة للإمبراطورية العثمانية إلى ثلاثة أقسام، و ألحقت بكل من (تركيا – العراق – سوريا) بالنتيجة فقد تم تقسيمها كمحصلة نهائية بين عدة قوميات متجاورة (العرب، الفرس، الترك، الأرمن، الآزريين ……..) على شكل كيانات سياسية وليدة اتخذت أشكال الدول الحديثة (سوريا، العراق، إيران، تركيا، بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق) تختلف كلياً أو جزئياً بحدودها المرسومة قسرياً (بالضد من إرادة شعوبها) عن بقعتها الجغرافية تاريخياً إذ أنها أيضاً خضعت للتقسيم والضم والإلحاق بشكل لم تعد تعبر فعلياً عن المنضوين تحت لوائها من شعوب وأقوام، فالكرد لم ينتمموا يوماً إلى البقعات الجغرافية لكلٍ من سوريا التاريخية، أو العراق(4) مثلاً و لكنه أصبح ينتمي قسراً إلى الكيانات الناتجة عن تلك التقسيمات(5) بما يمكن تشبيهه بزواج الإكراه الذي يستمر غالباً إذا ما هيأت له الظروف المناسبة و البيئة الملائمة أو قد يؤدي إلى القطيعة والطلاق بدون توفر تلك البيئة.
كردستان وكما تؤكد الوقائع التاريخية هو الموطن الأول للسلالة البشرية الثانية (بعد طوفان نوح ورسو سفينته على أحد جبال هذه المنطقة)(6) هو كتسمية (موطن الشعب الكردي) اصطلاح نسبي (نسبة إلى الكرد) أكثر منه واقعاً سياسياً – تاريخياً، فكما يؤكده كافة المؤرخين الذين تناولوا تاريخ الكرد وموطنه أن هذه البقعة التي عاش عليها الكرد منذ آلاف السنين لم تشهد وحدة سياسية متكاملة منذ عهود أسلافهم (الميتانيين) الذين أقاموا مملكة في جزء كبير من هذه البقعة (الجزء الغربي) كانت عاصمتها (واششو كاني) بالقرب من رأس العين الحالية (سري كانييه –Serê kaniyê )، و(الميدييين) الذين بنوا مدينة (همذان) أي (همدان الحالية) في كردستان الشرقية – إيران، و جعلوها عاصمةً لإمبراطوريتهم التي شملت الجزء الشرقي من هذه البقعة وجزء من بلاد فارس(7)، بل أقام الكرد على أجزاء منها ممالك عديدة وفي فترات تاريخية متتابعة إمبراطوريات وممالك كـ (المملكة الهورية – الميتانية، المملكة الحيثية، مملكة كوردئين أو كوردجيخ)(8) التي أقيمت حوالي القرن السابع قبل الميلاد. كما لم يشهد التاريخ الحديث كياناً سياسياً موحداً (دولة بالمفهوم الحديث) بحدود مرسومة أو معترف بها يطلق عليه اسم (كردستان) – إذا ما استثنينا فترات متقطعة وقصيرة كـ (مملكة كردستان الجنوبية) التي أعلنها الشيخ محمود برزنجي (محمود الحفيد) على إجزاء من كردستان الجنوبية – العراق، ونصب نفسه ملكاً عليها لكنها لم تدم طويلاً(9)، وإعلان جمهورية كردستان الديمقراطية (جمهورية مهاباد)(10) من جانب واحد على جزء آخر من هذه البقعة لمدة قصيرة، ولم تنل الاعتراف كما لم ترسم لها حدود قط، وكذلك إقليم كردستان العراق الذي لا يزال لم يفلح في ترسيخ دعائمه، ورسم حدوده النهائية – كذلك لم يكن ثمة حدود واضحة فاصلة بين ثناياها وجنباتها في العهود الغابرة بل كانت غالباً تتمتع بنوع من الاستقلالية الذاتية عن محيطها على شكل إمارات متعددة، وخاصةً منذ العهد الإسلامي وما تبعها كإمارات (هكاري، بدليس، بابان، بهدينان، صوران، رواندوز، حسن كيف، كلس وإعزاز………الخ)(11)، أو حكومات تابعة لامبراطوريات قائمة حينها / الحكومة السالارية في أذربيجان (300-420هـ)، الحكومة الحسنوية بهمدان (330-405هـ)،الحكومة الشدادية بآران (340-468هـ)، الحكومة الدوستكية والمروانية بدياربكر (350-370-476هـ)، حكومة بني عنان في حلوان (380-510هـ)، حكومات اللور الفضلوئية 0550-827هـ)، والخورشيدية (570-1250هـ)، في جنوب شرق لورستان/(12) بالمحصلة وحيث أنه لا شعب بدون أرض وتاريخ ولغة تشكل بمجموعها موطناً يسمى الكل حيث يسمى الجزء منه هنا أو هناك، أو يتخذ الكل مسمى أشمل من الجزء(13).
الانتماء يحدد الهوية القومية المستندة على الأصل واللغة بشكل أساسي أما الولاء فيحدد الهوية الوطنية أو الجنسية المرتكزة على الكيان السياسي والعقد الاجتماعي لذلك الكيان بصيغته القانونية (الدستور) وهي أعم وأشمل0لذلك فإن الهوية الوطنية السورية الحديثة (الجنسية) تتحدد بحسب الولاء الوطني الناتج عن العقد الاجتماعي المفترض أن يتم صياغته توافقياً بحيث يضمن المساواة التامة بين الجميع (أجناساً وأدياناً وأقوام) مما ينتج خضوعاً طوعيا لبنوده بمعنى أن يعتبر الجميع سوريون مهما اختلفت انتماءاتهم.
راهناً تكتنف الهوية الوطنية في العديد من بلدان المنطقة (ومنها الهوية الوطنية السورية) الكثير من الالتباس والنفور، وتكتسب صفة عنصرية كونها صيغت قسرياً وإقصائياً فهي لم تبرز كنتاج لعقد اجتماعي توافقي من جهة، ولتفكيك أوصالها بفعل الاستبداد الذي دمر جميع مقومات الدولة الوطنية التي تستند إليها هذه الهوية من جهة أخرى، فالاستبداد نقيض الوطنية بمقدار ما هو نقيض الديمقراطية، والسلطة الاستبدادية لا يمكن لها بحال من الأحوال صياغة مفهوم واضح وشامل للهوية الوطنية أو حمايتها.
اعتزاز المرء بانتمائه حالة طبيعية فطرية يفترض ألا ينتج حساسيات أثنية – قومية أو تجاذبات سياسية بل يولد مفهوماً جديداً وحضارياً للهوية الوطنية المشتركة، أو الجامعة في البلدان ذات التنوع الإثني – القومي، وعلى العكس من ذلك فإن الاضطرار لإخفاء الانتماء أو التخوف من إظهاره لدى البعض يندرج في إطار النزعة العنصرية أو رغبات الهيمنة للآخر المختلف قومياً مما يفقد الهوية الوطنية شموليتها (كونها تشمل الجميع)، فاعتزاز الكرد بانتمائهم لموطنهم التاريخي يتماشى ويتوافق مع اعتزاز العرب والترك والفرس وغيرهم بانتمائهم لموطنهم.
الشعور بالولاء لكيان ما يشمل جزءاً أو كلاً من الموطن الأصلي لا يتناقض مع حقيقة الانتماء لهذا الجزء أو ذلك الكل، والتعارض بينهما يعني اختلالاً في التوازن للكينونة الوطنية، فليس ثمة أولوية أو أحقية للانتماء على الولاء إلا إذا فشل الكيان السياسي من تحقيق كينونته المفترضة القائمة على تحقيق مصالح الجميع بشكل متوازن، فسوريا بحدودها الحالية (المعترف بها دولياً) يمكنها أن تحقق للكرد حقوقهم وحاجاتهم ومصالحهم بشكل لا يحققه لهم انتمائهم الكردستاني، وبذلك تضمن ولائهم المطلق لانتفاء حاجتهم (أي الكرد) حينها لكيان آخر يستند على جزئية الانتماء فقط، ولا يحقق لهم أية مصالح خاصةً في ظل عدم وجود كيان آخر يحقق الانتماء والولاء معاً في الحالة الكردية هذه، كذلك قد تحقق سوريا للكرد ما لا يستطيع الكيان الكردستاني الشامل تحقيقه (مع افتراض تشكله لاحقاً) لتشابك المصالح والحاجات الأساسية بين الشركاء في الدولة الواحدة، حيث الدولة السورية الحديثة سابقة للكيان الكردستاني المفترض تشكله لاحقاً، والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم (سويسرا، النمسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، ………..الخ)0 بالمقابل فإن شعور الكرد بالغبن أو عدم شعورهم بالأمان والاطمئنان على مستقبلهم في سوريا خلق لديهم سابقاً، ويخلق لاحقاً رغبة البحث عن كيان بديل حتى في أقاصي الأرض مما يعزز الجنوح اللاواعي نحو أولوية الانتماء للموطن الأصلي والولاء له دون سواه – ولو نظرياً – مما يقوي النزوع نحو التقوقع والسلوك الانقسامي – التشتيتي وهو ما حصل في الأمس القريب مع شعوب البلقان، وقبلهم شعوب الاتحاد السوفيتي السابق(14).
بناءً على ما سبق فإن انتماء الكرد في سوريا إلى كردستان (أي كردستانيتهم) باعتبارهم يعيشون على جزء من أرضهم التاريخية، ولم يأتوا إليها مهاجرين أو عابري سبيل لا يتعارض مع ولائهم الوطني السوري، مثلما لا يتعارض انتماء العربي في سوريا لجزء من موطنه العربي – أرضه التاريخية – مع ولائه الوطني السوري. كذا فإن انتماء الألماني أو الطلياني لأرضه في سويسرا مثلاً لا يتعارض مع ولائه لها كدولة كونها قائمة على عقد اجتماعي يضمن حقوق الجميع على الرغم من وجود كيانات سياسية أخرى (دول) مجاورة لكل من الشعب الألماني (ألمانيا)، والطلياني (إيطاليا)، وكذلك للشعب العربي في سوريا (الدول العربية) بعكس الشعب الكردي. بالنتيجة فإن الكردي في سوريا كردستاني الانتماء تاريخياً سوري الولاء استناداً للعقد الاجتماعي (الدستور) الذي من المفترض أنه سيشارك في صياغته، وبه فقط لأنه وحده الضامن بإضعاف الانتماء السابق (الكردستاني) وتعزيز الانتماء اللاحق (السوري) باعتبار انتمائه الكردستاني الموغل في القدم سابق لانتمائه السوري الحديث العهد نسبياً.
في الواقع إن طغيان الحالة الكردستانية على الوعي الكردي عامةً يعود في الأساس إلى المعاناة المستمرة والفظاعات التي ارتكبت بحقه على أسس قومية في ظل دول تكونت بمعزل عن إرادته، وسادت فيها النزعة العنصرية، وأقيمت فيها أنظمة حكم تميزت بمركزية مطلقة ومتشددة.
في الحالة السورية فقد تأرجح تأثر الكرد السوريين على مر السنين بين انتمائهم الكردستاني وولائهم السوري في حالةٍ فريدة تميز بها الواقع الكردي في سوريا وذلك نتيجة تقلبات الأوضاع وبرودة أو سخونة الأحداث في الساحات المختلفة التي تهم الكرد من جهة، علاقة هذا الطرف الكردستاني أو ذاك بالسلطات السورية والأحزاب الكردية في سوريا من جهة ثانية، وقد طغى غالباً اهتمام الكرد بما يجري في الساحات الكردستانية الأخرى على همهم الكردي والوطني السوري لأسباب عديدة لعل أهمها الظروف التي أحاطت بتأسيس أول حزب كردي في سوريا وارتباطه لاحقاً أو بعضاَ منه – بعد انقسامه – بالجهات الكردستانية الفاعلة حينها ثم بمحاور كردستانية تالياً من جهة، وسخونة الأحداث في الساحات الكردستانية مقارنةً مع برودة الأوضاع أو هدوئها نسبياً في الساحة الكردية السورية نظراً لاختلاف طبيعة النضال المتبع (سياسي سلمي أو كفاح مسلح) من قبل الحركات الكردية في كل جزء من جهة ثانية، وتدخل بعض الحركات والأحزاب الكردستانية في الوضع الداخلي الكردي مستغلةً بعض جوانب الخلل أو التقصير والانقسام لدى الأحزاب الكردية لجذب الاهتمام والأولوية نحو ساحاتها من جهة أخرى. فضلاً عن محاولات النظام الحثيثة لتوجيه أنظار الكرد نحو الساحات الكردستانية الملتهبة، وغض النظر بل تشجيعهم أحياناً على المساهمة في الحراك الكردي الثوري هناك(15) – ليس رغبةً في دعمهم أو المساهمة في إيجاد حل لقضيتهم، أو لرضاه عن زعمائهم في تلك الأجزاء، كذلك لم يكن دوماً لتنفيذ أجندات أو تحقيق مصالح مشتركة بينهم، بل لإلهاء الكرد السوريين عن قضيتهم الأساسية، وتحريف بوصلتهم عن التناقض الأساسي باتجاهات أخرى، وتشتيت شملهم، ودب الفرقة بينهم على وقع الخلافات بين الأطراف الكردستانية من جهة، والإيحاء ثم الترويج لتبعية الكرد للجهات الكردستانية تأكيداً لمزاعمه بخطورة الحراك الكردي على وحدة التراب والكيان السوري، ثم محاكمة نشطاء الكرد وتجريمهم على خلفية التبعية المزعومة تلك من جهة ثانية – ثم ربط القضية القومية وحقوق الشعب الكردي تالياً بالتجاذبات الإقليمية، وجعلها مادةً دسمة للمساومات والصفقات السياسية من جهة أخرى(16). على الرغم من ذلك لم يشهد الواقع الكردي السوري حراكاً احتجاجياً أو ثورياً على وقع الاحتجاجات أو الثورات الكردستانية تلك، ولم تتجاوز ردات الفعل الكردية مشاعر الحزن أو الفرح لمآلات واقع أشقاءهم، أو تضامناً أخلاقياً ووجدانياً مع مطاليبهم، أو مساعدات إنسانية، بعكس ما جرى عند انطلاقة الاحتجاجات والمظاهرات في درعا، فقد كان الكرد سباقين في اللحاق بها، وكانت صدى المظاهرات تتعالى في كل المناطق الكردية، ويتم فيها ترديد شعارات وأناشيد الحرية والكرامة كما كل الأراضي السورية في تلاحم نضالي طوعي وواعٍ قل نظيره – على الرغم من محاولات النظام الحثيثة لفك عرى الارتباط بينها – لتؤكد مرة أخرى وحدة المصير والمصالح، وبالتالي الأهداف على الرغم من اختلاف الثقافات، وما يلازمها من اختلاف الرؤى والسياسات، كذلك المرجعيات والعواطف.
لم تشهد الساحة السورية حالاتٍ مشابهة منذ عهد ثورات الأجداد ضد الاحتلال الفرنسي التي شارك فيها الكرد بشكل كبير إلى جانب كافة أطياف المجتمع السوري (ثورة ابراهيم هنانو، محو إيبو شاشو، معارك عامودة وبياندور وحي الأكراد في دمشق، …………… الخ)(17) حيث انتعشت آمال الجميع حينها بقرب الخلاص من الاستعمار، وبناء الدولة المشتركة التي تحفظ حقوق الجميع،وكذلك الفترة القصيرة التي تلت استقلال الدولة السورية حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي حيث لم تكن النزعة القومية العنصرية قد ترسخت بعد مما أفسح المجال لمشاركة الكرد في بناء الدولة السورية، وقد تبوأ الكثير منهم مراكز هامة وحساسة كرئيس الجمهورية «حسني الزعيم»، وأول رئيس حكومة «محمد علي العابد»، و شخصيات سياسية ودينية، مهنية وفنية عديدة أخرى كان لهم دور بارز في تاريخ سوريا، على الرغم من حدوث حالات وأشكال عديدة من التمرد على السلطات لاحقاً كما في أحداث الستينات والثمانينات من القرن الماضي والانتفاضة الكردية عام /2004م/ فإنها جميعاً تميزت بالتفرد والانعزالية نظراً لغياب التكامل الوطني عنها إضافة لعوامل أخرى إثر هيمنة نزعة التسلط والاستئثار، وسيادة ثقافة العنصرية والاستبداد(18).
إذاً فإن تعزيز ولاء الكرد للكيان السوري كوطن (أي طغيان البعد الوطني للمسألة الكردية على الوعي الكردي) مرتبط إلى حد كبير بانتعاش الآمال بإيجاد حل عادل لهذه القضية على المستوى الوطني، وتراجع أو اضمحلال الرؤى والأطر ما دون الوطنية(19)، ويطغى البعد القومي المتمثل في الإنتماء بتلاشي تلك الآمال أو ببروز عقبات في طريق تحقيقها. من هنا فإن الاهتمام بالبعد القومي لم يكن ليظهر لولا تنكر الحكومات وكذلك تجاهل المعارضات لحقوق الشعب الكردي المشروعة، وتعالي الرغبات القومية ذات الطابع الشمولي، فإذا كانت السلطات قد تحملت سابقاً مسؤولية رجحان الهم القومي الكردي المستند إلى تاريخية الانتماء على حساب الولاء الوطني المرتكز على هشاشة التكوين والهوية، فإن المعارضة السورية الحالية بتياراتها المختلفة (الدينية، القومية، العلمانية، ……… ألخ) في ظل الأوضاع الراهنة أصبحت هي من تتحمل مسؤولية ظهور مثل هذا الطغيان مجدداً نظراً لغياب مشروعها الوطني المتكامل، وترنح حوامل شرازم المشاريع الوطنية لصالح المشاريع الفئوية ما دون الوطنية التي تلاقي الدعم من الحواضن المذهبية – الطائفية في الجوار الإقليمي القريب والبعيد على حد سواء، إذ ليس بالإمكان محو البعد القومي أو إلغاؤه لارتباطه بالمشاعر والأحاسيس والعواطف وبالتالي بالكرامة القومية بل يمكن تقويمه أو تحجيمه بإنعاش البعد الوطني الممكن تجسيده عملياً كونه مرتبط بالمصالح المشتركة والمتبادلة القابلة للتحقيق على أرض الواقع وذلك يإعادة صياغة مفهوم جديد وواضح للهوية الوطنية يحقق العدالة والمساواة بين الجميع. حالياً وفي المنظور القريب وبسبب تدمير البنية التحتية لمرتكزات العملية السياسية في سوريا، وانهيار المنظومة الفكرية لعملية التغيير والبناء، وإذا ما أضفنا لذلك بروز التيارات الإسلامية المتشددة التي تتخذ من العنف والإرهاب سلوكاً ومنهجاً، وسيطرتها على مساحات شاسعة ومناطق ذو أهمية استراتيجية ترافقاً مع بقاء صيغة الحكم الاستبدادي سائداً إلى أجل غير مسمى، فإن الهوية الوطنية السورية باتت مهددة بالإنقراض والزوال نهائياً، والتفتت إلى هويات جزئية عصبية دون وطنية، وإن إعادة صياغة مفهوم حضاري للهوية الوطنية لا يمكن له أن يتم بدون وجود مشروع استنهاض وطني يستنهض من بين الأنقاض، ويتجاوز المنظومة الفكرية العقائدية والايديولوجيات العصبية واسقاطاتهما السابقة، ويتفهم الصيرورة الوطنية الحضارية، ويعتمد المعايير العالمية الحديثة في تكوين الدول(20).
الهوامش والمراجع:
1-السلجوقيون هم أول من أطلقوا اسم كردستان على هذه البلاد، وقد ورد ذلك في خلاصة تاريخ الكرد وكردستان للعلامة محمد أمين ذكي.
2-محمد أمين ذكي، تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي.
3-محمد أمين ذكي، نفس المصدر السابق.
4-سوريا التاريخية والعراق تاريخياً هما بقعة جغرافية منذ القدم من منطقة الشرق الأوسط تختلف حدودهما عن الحدود الحالية الناتجة عن اتفاقية سايكس – بيكو.
5-أقرت اتفاقية سيفر بين دول الحلفاء والدولة العثمانية على حكم ذاتي للكرد في إطار الدولة العثمانية على أن يتم إجراء استفتاء فيما بعد بين الكرد لتقرير مصيرهم سواء بالبقاء أو الانفصال عنهان ولكن هذه الاتفاقية لم تر النور.
6-القرآن الكريم «واستوت على الجودي» وهو جبل في كردستان حالياً، وقد تم اكتشاف بقايا من المواد التي صنعت منها السفينة في مناطق من هذا الجبل.
7-محمد أمين ذكي، خلاصة تاريخ الكرد وكردستان.
8-محمد أمين ذكي، نفس المصدر السابق.
9-محمد أمين ذكي، تاريخ الدول وافمارات الكردية في العهد الإسلامي.
10-د. عبد الرحمن قاسملو، كردستان والأكراد، فقد تم إعلان جمهورية بحكم ذاتي عاصمتها مهاباد من جانب واحد تحت قيادة (قاضي محمد) ودامت إحدى عشر شهراً فقط من 22/1/1946 إلى 17/12/1946م.
11-محمد أمين ذكي، تاريخ الدول والإمارات الكردية في العهد الإسلامي.
12-محمد أمين ذكي، نفس المصدر السابق.
13-تم إقامة ثلاث حكومات باسم كردستان في تواريخ مختلفة وعلى أجزاء من هذه الأرض، ومنه يمكن إطلا هذه التسمية على كل هذه البقاع من الأرض.
14-انقسام كل من تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا، والاتحاد السوفيتي في أواخر القرن الماضي.
15-تم تجنيد الكثير من الشباب الكرد السوريين في الثورات الكردية في كل من العراق و تركيا بغض نظر من السلطات السورية أحياناً، وتشجيع ودعم منها أحياناً أخرى.
16-غالباً ما أصبحت القضية الكردية ضحية مساومات وصفقات دولية كاتفاقية لوزان بين دول الحلفاء والدولة التركية الكمالية عام /1923م/ التي تمت على أنقاض اتفاقية سيفر، واتفاقية الجزائر بين العراق (صدام حسين) وايران (الشاه محمد رضى بهلوي) وبرعاية الرئيس الجزائري حينها (هواري بو مدين) في /11/آذار /1974م/.
17-شتات من المراجع الكردية والمنشورات الحزبية.
18-تمكنت السلطات حينها من عزل مناطق الاحتجاج والتمرد (حركة الإخوان المسلمين) عن باقي المناطق، واستثمار الجانب العنصري لصالحه في الإنتفاضة الكردية عام /2004م/ وعزلها عن البعد الوطني.
19-يقصد هنا بالأطر ما دون الوطنية المرجعيات الفئوية، والطائفية، والعشائرية، وما شابهها.
20-المعايير الحديثة تشمل نموذجين من الدول الديمقراطية، الدول اللاقومية كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرهما، والدول متعددة القوميات كسويسرا، النمسا، المملكة المتحدة …….الخ.