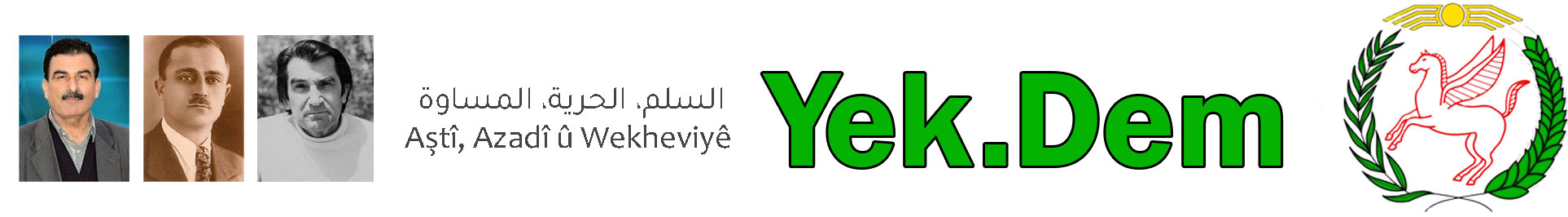قاد أردوغان وحزب العدالة والتنمية انتقال تركيا إلى مستوًى نوعي جديد، سياسيًا واقتصاديًا، فصارت إحدى الدول العشرين الأفضل في معدلات نموها، مع طموح أن تصل إلى موقع أفضل خلال السنوات القادمة. هكذا، تشكل لدى تركيا فائض قوة، سوف تسعى إلى تصريفه بحكم الضرورة، وتوظيفه، كما يفعل مراهق أو شاب معتدّ بقوة جسدية مستجدة لديه، تبعث فيه دوافع ورغبة التعبير عنها، وتجسيدها، فيكون أمامه سبيلان لتصريف قوته هذه: أحدهما سيئ وهدام، بمشاجرات واعتداءات على من هم أقلّ قوة منه، وثانيهما بنّاءٌ وإيجابي، بممارسة نوع من أنواع الرياضات الكثيرة المتوفرة. تصدير فائض القوة التركي ضرورة حتمية، وسنّة تاريخية، سارت عليها قبلها دول كثيرة، والاحتلالات العسكرية في الماضي كانت إحدى تجسيدات هذا القانون التاريخي؛ فالعشائر الأكبر عددًا، والأقدر على تجنيد المحاربين، كانت تغزو الأقل عددًا، لتسيطر على مواردها، وحملات المغول والصليبيين وتوسع الإمبراطورية الرومانية كانت شكلًا من أشكال استخدام القوة الفائضة عن حاجات الدولة الداخلية، وبعد الثورة الصناعية؛ اضطرت الرأسماليات “الوطنية” إلى استخدام عوامل قوتها الزائدة هذه للتوسع خارجيًا، لتأمين أسواق تصريف لمنتجاتها، والحصول على مواد أولية تلقمها لفم اقتصادها المفتوح طالبًا المزيد والمزيد. اليوم، نحن إزاء نوعين من الاحتلالات، فمن يقوم بالاحتلال، يفعل ذلك تصديرًا لفائض في القوة، أو ترحيلًا لأزمة داخلية، فالعراق احتلّت الكويت، وإيران تتوسع في محيطها، وروسيا كذلك، ترحيلًا لأزمة عميقة وبنيوية، وشاملة، باستخدام بُعد واحد، بائس من أبعاد القوة، أي القوة العسكرية. أما أميركا، فقامت به، وقبلها بريطانيا، وفرنسا، استعمالًا إجباريًا لفائض قوتها المركبة، غير الأحادية والمقتصرة على بعد واحد، وبعد موجة الاستقلالات الوطنية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، طوّرت دول الاستعمار هذه أدواتها للحصول على النتائج المتوخاة من ممارسة الاحتلال باستخدام القوة العسكرية، فرأس المال صارت لديه خيارات متعددة لأقلمة وتكييف الاقتصادات المتأخرة ذات وتائر النمو المنخفضة مع حاجاته ومتطلباته، مستخدمًا، إضافةً إلى القوة العسكرية، النظامَ المالي العالمي وقدرته على الإقراض، وتفوقه التقني، وعلو كعبه في الإنتاج الفكري والثقافي. تراجع أهمية القوة العسكرية في التمدد الخارجي لا يظهر فقط في ما سلف، فها هي ألمانيا تتعظ من تجربة هتلر، وتبدل قنوات تصريف فائض قوتها الاقتصادية -التقنية، فتقود اليوم مشروع الاتحاد الأوروبي. أي خيارات كانت أمام تركيا لتصريف فائض قوتها المستجد؟ كان أمامها خياران: الأول، هو الاتجاه غربًا، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانصهار كليًا في منظومته، والانضواء في ظل استراتيجياته، والمعاناة من مشكلاته مثلها في ذلك مثل أي عضو فيه، وهذا يتطلب خطابًا وممارسةً سياسيين ينسجمان مع قيم الاتحاد، يقومان على الدمقرطة وحقوق الإنسان والحريات العامة… إلخ. أما الثاني، الاتجاه شرقًا، إلى ماضيها الإمبراطوري في الشق الشرقي منه، لأن الشق الأوروبي عسير الهضم عليها، بل مستحيل، ولا شك أن الخطاب والممارسة السياسيين سيكونان من طينة مناسبة لهذا التوجه، يعتمدان على مداعبة الأحاسيس والأفكار الدينية، ودعم حركات الإسلام السياسي فيه، واستغلال عطشها المزمن للسلطة، وإكساء عنتها التاريخية بفحولة تركيا المستجدة. سُدت أبواب الخيار الأول في وجه تركيا؛ بسبب المماطلة والتسويف الأوروبيين في قبول عضويتها في اتحادهم، ولأسباب ثقافية، أهمها خوف أوروبا المزمن من الإسلام، وحضور الخصومة التاريخية بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية منذ أيام هانيبال ثم الغزو الإسلامي لأوروبا في ذهن الأوروبيين شعوبًا ونخبًا سياسية، وليس أدل على ذلك من جملة حقائق تتجاوز جزئية ماراتونية مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد، منها مثلًا، مسارعة هذا الاتحاد إلى ضم دول شيوعية سابقة، على الرغم من تكلفة هذا الضم الهائلة على الاقتصاد الأوروبي بسبب تأخر وتخلف اقتصاديات هذه الدول، وعدم قبول عضوية تركيا الجاهزة اقتصاديًا، التي تعتبر إضافتها إلى الاتحاد مكسبًا كبيرًا للاقتصاد الأوروبي، وذات فائدة مشتركة للطرفين: الأوروبي والتركي. من ملامح حضور عُقد الماضي في أوروبا مثلًا، يمكننا استحضار واستذكار الحرب الممتدة في إيرلندا حتى عهد قريب، ومجازر البوسنة، وقرار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد، وعدم السير في ركاب هذا المشروع الأممي، ما فوق قومي، لإحياء أمجاد “الأمة البريطانية” وانتصارًا “لخصوصية” بريطانيا التي كانت عظمى، وصعود اليمين المتطرف سياسيًا في عدد من الدول، على خلفية الخوف من التأثير الثقافي لعدد من اللاجئين لا تتجاوز نسبتهم إلى مجموع سكان أوروبا، واحدًا إلى ألف. لم يكن أمام تركيا، والحال هذه، إلا التوجه شرقًا، وجاء توقيت هذا متزامنًا مع مخاضات تعيشها المنطقة في تونس ومصر وسورية، برز فيها الإسلام السياسي لاعبًا مهمًا، فكان من الطبيعي أن تكون رهانات السلطة في تركيا معقودة عليه، لأسباب لا تتعلق بتصدر الإسلام السياسي المشهد فحسب، بل، إضافة إلى ذلك، طبيعة الأيديولوجيا التي يتبناها حزب العدالة والتنمية التركي وقائده أردوغان. العضوية في نسيج أيديولوجي واحد، وتجذر الدين في عقول شعوب الشرق، والهوس التاريخي بإعادة أمجاد “الأمة”، سواء أكانت عربية أم إسلامية، كانت حوامل التوجه التركي نحو الشرق، الذي لم يحفزه شيء قدر تردد أوروبا في الانسجام مع قيمها المعلنة، وعجزها عن تشكيل اتحادها السياسي، تعبيرًا عن تجاوزها مرحلة “الوطنية”، ونوسانها بين ماضيها القائم على هذه الوطنية، ومستقبلها ما فوق الوطني الذي تطمح إليه، لا بل انتعاش اليمين فيها الذي يعلن جهارًا نيته تفكيك الاتحاد الأوروبي، بوصفه اعتداءً على الوطنيات البريطانية والفرنسية والألمانية… إلخ. لقد فوّت موقف أوروبا من تركيا على الطرفين فوائد جمة، وعلينا كذلك، فلو تمّ ضم تركيا إلى الاتحاد لكان ذلك بمثابة إعلان أوروبي عن قطيعة مع هواجس الماضي، وتشويشات الحاضر بمخاوفه “الثقافية”، واقترابًا أكثر من قدوة أوروبا أي الولايات المتحدة الأميركية؛ كما كانت سوف تعني بالنسبة إلى تركيا انغماسًا نهائيًا في الغرب، الذي سيكون قادرًا على استيعابها و”استقلابها” بمنظوماته متعددة المستويات، الاقتصادية والثقافية والسياسية، ويكبح، بل يمنع جموحها باتجاه الشرق وبهذه الطريقة والأدوات والأساليب. أما عن فائدتنا نحن، فسوف تكون عدم تعويل حركات الإسلام السياسي على أوهام ماضوية، تتعلق بإعادة أمجاد “الأمة الإسلامية”، وما يستتبعه ذلك من آثار على مجتمعاتنا وبنية عقلنا السياسي وديناميات الصراع السياسي في المنطقة، التي اشرأبت أعناق شرائح واسعة منها نحو “السلطان الجديد” باعث مجد الخلافة، وفق تصوراتها وأمنياتها، ونمط “تحليلاتها” السطحية والشكلانية للحالة التركية. لعنة الماضي هذه، وهي لعنة شاملة كما يبدو، تطال أوروبا وتركيا والعرب، هي التي كانت وراء انزياح خطير في الديمقراطية التركية الناشئة، عبر دخول النظام السياسي التركي نفق الاعتماد على شخص، وهو نفق ربما يكون نيلسون مانديلا هو الوحيد الذي جنب بلاده الدخول فيه في العقود الأخيرة، إذ تنبه إلى أن كاريزما شخصه يجب أن لا تلعب دورًا محوريًا في بنية نظام جنوب إفريقيا، بينما بالمقابل نلحظ بروز ظاهرة الاعتماد على الشخص في ديمقراطيات عريقة، ورائدة، كالولايات المتحدة الأميركية، التي حصر التنافس في نظامها السياسي الرئاسي على مؤسسة الرئاسة، بين عائلتي بوش وكلينتون، وهو ما أدى، إضافة إلى جملة عوامل أخرى، إلى ظهور ظاهرة ترامب، الذي ربما لو كان مرشح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة “ساندرز” لكانت نتائجها غير ما أسفرت عنه، إذ اضطر الكثير من الأميركيين إلى منح أصواتهم لترامب، من باب رغبتهم في التغيير، وهذا ما حل أيضًا في ألمانيا بانتخاباتها العام الماضي أيضًا، فالكثير من الألمان منحوا أصواتهم لحزب البديل AFD، بسبب رغبتهم في كسر حالة الرتابة التي رافقت بقاء الائتلاف الحاكم في السلطة وممثلته ميركل. بالتأكيد، ديمقراطيات عريقة، كالأميركية والألمانية، تمتلك من أدوات وآليات المراجعة ما لا تملكه ديمقراطيات مستجدة كتركيا، تمكنها من تلافي الآثار السلبية لاعتماد النظام السياسي على شخص، وهذا ما تفتقر إليه الديمقراطية الناشئة، غير المتجذرة في تركيا، لأن من يقودها شخص وحزب يحملان أيديولوجية شمولية، ومعرضة بشدة لمخاطر أزمات كيانية وهوياتية، ومضطرة، بسبب توجهها نحو الشرق وتحالفاتها مع أنظمة شمولية ومافيوية كإيران وروسيا، إلى زيادة حضور الأيديولوجيا في سياساتها الخارجية وخطابها (مثلًا قرار منع تدريس نظرية داروين في المدارس التركية) وهذا النزوع، أو بدء السير في طريق التحول إلى الديكتاتورية لا يتجلى فحسب بأهمية شخص أردوغان، الأهم هنا، والأخطر، هو بدء السير باتجاه تقزيم الديمقراطية وجعلها مقصورة على إحدى أدواتها، أي ممارسة الانتخابات، والخطوة الأولى في هذه السيرورة بدأت بانزياح الصلاحيات بين المؤسسات تبعًا للشخص، وأعني هنا مؤسستي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، فحيث يكون أردوغان تميل الصلاحيات. نجح أردوغان في الانتخابات الأخيرة، لكن تركيا كلها ونظامها السياسي دخلا سيرورة مركزية الشخص، الكارثية، التي تهدد البنية التركية برمتها، وهذا ما ينبغي على الحصيفين أن يروه، ويفكروا فيه، إن خطر لهم التساؤل: ماذا كان سيحلّ بماليزيا التي اضطرت إلى إعادة العجوز مهاتير محمد للسلطة، لو أنه كان ميتًا؟ ماذا سيحل بالجزائر بعد وفاة أبو تفليقة؟ وما هو مصير تركيا إن أصابت “السلطان” ذبحة قلبية مفاجئة؟!
* جريدة الوحـدة – العدد /297/ – حزيران 2018 – الجريدة المركزية لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)