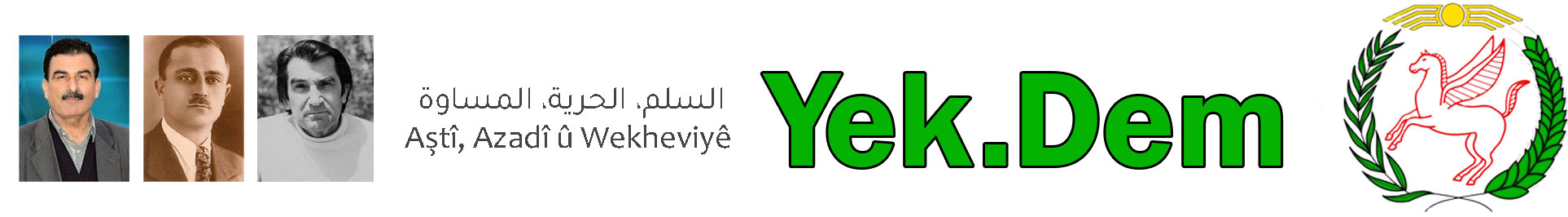* أستاذ جامعي وباحث في التاريخ – كردستان العراق.
مجلة الحوار – دراسات وأبحاث – العدد /71/ – السنة 25- 2018
البُختية – البوهتانية – بوهتان:
البُختية، قبيلة في غنى عن التعريف، فهي من أشهر القبائل الكُردية وأكبرها خلال العصور الوسطى والعصر العثماني، وورد اسمها في أخبار عمليات الفتح الإسلامي حسب قول المستشرق شترك ([1])، واقترن اسمها بولاية بوهتان – جزيرة ابن عمر، فعرفت بـ «ولاية البُختية» ([2]). والغريب ان المسعودي والمقريزي لم يذكرا البُختية عند حديثهما عن القبائل والطوائف الكُردية.
وبُختي أو بُختو اسم قديم جداً يعود جذوره إلى القرن الخامس قبل الميلاد في أقل تقدير، فقد ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوتس (485 – 425ق.م) مقاطعة باسم بختويخ (Pekhtuikh) وقال أنها كانت تقع ضمن الساتراب (الولاية) الثالث عشر للدولة الاخمينية (559 – 331 ق.م)، ويرى المستشرق الالماني ثيودور نولدكه ويؤيده كيبرت ان لبختويخ علاقة مع بهتان الحالية، وان البُختية هم القوم الذين ذكرهم هيرودوتس عند حديثه عن الأرمن، إما مارتن هارتمان فيشك في هذا الرأي مستنداً في ذلك إلى اختلاف التلفظ([3]).
وحسب رواية شعبية دارجة غير موثقة تاريخياً، نقلها شرفخان البدليسي من الإخباريين والرواة الثقاة ممن لهم اطلاع وإلمام بتاريخ قبيلة البشنوية، ان بختو – بوهتان في الأصل هو اسم علم، وبجني – بجنو – بشنو – البشنوية صاحبة قلعة فَنَك–كانا أخوين من سلالة حكام الجزيرة، فنشب الخلاف بينهما إلى أن استقر الأمر لبختي واستتبت الحكومة له، وفَرّ بجني – بشنو إلى بلدة حصنكيفا، وإلى جانب ذلك، يروي البدليسي رواية أخرى كانت شائعة بين الكُرد مفادها: «ان الشعوب الكُردية كلها من سلالة بجني – بشنو وبُخت – بوهتان» ([4]).
هذه الرواية الأخيرة، ان دلت على شيء، فإنها تدل على قدم اسم بوهتان والقبيلة البُختية، على الرغم من أنها أقرب إلى الأساطير والحكايات الشعبية منها إلى الحقائق التاريخية.
ومما لها دلالاتها أيضاً على عراقة البُختية ، هي انها كانت معروفة كـ «قوم من العجم» منذ وقت مبكر جداً من العصر الاسلامي، اذ يحكى أن عدي بن أرطأة أمير البصرة(99-101هـ/718-719م) رأى في المنام كأنه يحتلب بختية ، فأحتلب لبنا ثم احتلب دما، فكتب رؤياه في صحيفة وبعث بها مع رجل إلى مفسر الاحلام المعروف محمد ابن سيرين(33-110هـ/653-728م) وقال لا تعلمه أني رأيت هذه الرؤيا، فجاء الرجل فجلس ثم تحدث مع ابن سيرين ،ثم قال رأيت في المنام كأني احتلب بختية لبنا ثم احتلبتها دما، فقال ابن سيرين هذه الرؤيا لم ترها أنت رآها عدي بن أرطأة ، فانطلق الرجل إلى عدي فأخبره بذلك، فأرسل عدي إلى ابن سيرين، فأتاه، فقص عليه الرؤيا، فقال ابن سيرين: أما البُختية فهؤلاء قوم من العجم والحلب جباية واللبن حلال جبيتهم حلالاً، ثم تعديت فجبيتهم حراماً الدم، تجاوزت ما أحل الله لك إلى ما حرم عليك، فاتق الله وأمسك([5]) .
واشتهرت البُختية بين قبائل كردستان بالشجاعة والمثابرة والإقدام، وحب التضحية بالنفس والنفيس في سبيل العزة والكرامة، كما امتازت بمهارتها في النظم العسكرية وفنون الفروسية ([6]). وهي أيضاً كالروذكية والسليفانية والطوران والمللية والهكارية تجمع قبلي واسع ضم عشرات العشائر والبطون المقيمة بالقلاع والنواحي الخاضعة رسمياً للأمير البوختي – البوتاني وعدت في الوقت نفسه ممتلكات العشيرة الوراثية، واعتبرت جميعها من رعايا الإمارة البُختية، واقترنت أسماء بعضها بأسماء القلاع التي بحوزتها، فصار البُختية اسم جامع لها وطغى على أسمائها المحلية، مع إننا نجد بينها قبائل كبيرة اشتهرت كقبيلة مستقلة ومستقرة في ولايات أخرى مثل دنبلي و شيروي – شيرواني.
والعشائر والبطون البُختية هي:
شهريوري، شهريلى (ينظر الشهرية)، طورطيل، أستورى، نيويدكاون (؟)، شورش، هيودل، والثلاثة الأخيرة على الديانة اليزيدية، بركة (بركي)، أروخي، بروز (به روزي) وتتألف من جاستولان وبزم وكرافان -كرافيان، كارسي، جَلكي -جه لكى من قرى ناحية برواري بالا، شيَلدى ومنها قرية شيلادزى على نهر الزاب الأعلى والتابعة لقضاء العمادية – محافظة دهوك، أي قبيلة شيلدى المقيمة على نهر الزاب-زي، برازي، قرشي وهي معروفة منذ أيام الغزو المغولي، دُنبلي، نوكي، محمودي، شيخ بزيني، ماسكي، رشكي، مخ نهران(؟)، بيكان، بلان، بلاستوران، شيرويان، دوتوران([7]) .
والبُختية على الرغم من كونها قبيلة كبيرة وذات تاريخ معروف في كردستان، فان رجالها لم يلتحقوا بالأيوبيين حتى بعد أن مد الأيوبيون نفوذهم إلى جزيرة بوهتان وغيرها من المدن المجاورة وصارت بلاد الجزيرة باسرها خاضعة لهم، وذلك بخلاف قبائل الجزيرة الأخرى كالمهرانية والهكارية والحميدية، كما لم يظهر بين الكُرد البُختية فقهاء وعلماء الحديث وشعراء معروفون على نطاق العالم الاسلامي ،سوى المدرس الشافعي صدرالدين سليمان بن موسى بن سليمان البختي المتوفى سنة 722هـ/1322م والشهير بالصدر سليمان الكُردي الذي تولى التدريس بالمدرسة العذراوية بدمشق سنة 710هـ/1310م والمدرسة عرفت نسبة إلى بانيها الست عذراء بنت نور الدولة شاهنشاه بن ايوب، ونشبت خلافات ومنازعات بين الصدر الكُردي وصدر الدين بن الوكيل حول التدريس في العذراوية، وبعد سنة عزل قراسنقر المنصوري عن ولاية دمشق، فتخلى الصدر الكُردي عن التدريس بالعذراوية ورافق قراسنقر، ونابه في الحكم بحلب([8]) .
-الإمارة البُختية:
إمارة بوهتان أو إمارة الجزيرة، إمارة كردية عريقة وذات تاريخ غابر مشرق، فهي من أقدم الإمارات الكُردية وأطولها عمراً، إذ ظلت قائمة –ولو بصورة متقطعة – منذ العهد البويهي الذي يمثل العصر الذهبي للامارات الكُردية إلى أواسط القرن التاسع عشر حين أسقطتها الدولة العثمانية مع جميع الإمارات الكُردية الأخرى، وواجهت خلال تاريخها الطويل لحالات مد وجزر كثيرة، وتعرض لغارات وحملات قوى وجهات محلية وإقليمية عديدة من الغز والسلاجقة وحكام الموصل مثل جيوش بك وعماد الدين زنكي وبدرالدين لؤلؤ والخوارزمية والمغول وتيمورلنك وأمراء القره قوينلو والآق قوينلو (قره يوسف القره قوينلو وقره إيلك الآق قوينلو وأوزون حسن) وانتهاء بالصفويين والعثمانيين، وقد أدت بعض هذه الاعتداءات بطبيعة الحال إلى احتلال بلاد البُختية وخرابها وفقدان أمراء بوهتان لسلطتهم وسيادتهم لبعض الوقت.
ولا تزال المعلومات عن إمارة الجزيرة محدودة وتاريخها غامض – لاسيما فيما يخض تاريخها خلال العصر العباسي وعهود الاحتلال المغولي والتركي والتركماني أي العهود التي تسبق الاحتلال العثماني لكردستان.
وينتمي أمراء الجزيرة الكُرد جميعهم إلى قبيلة البُختية الكبرى التي عرفت إمارة الجزيرة ومدينة الجزيرة ذاتها باسمها منذ ما قبل العصر العثماني. وتعد الامارة البُختية أطول الأمارات الكُردية عمراً وكانت صاحبة اليد الطولى في بلاد الجزيرة والزوزان وامتلك زعماؤها بهذه المناطق منذ العصر العباسي قلاع وحصون عديدة منها حزدقيل (كوركيل) وآتيل وعلوس([9]).
وبسط أمراء البُختية سيطرتهم على قلاع وحصون وقرى جبلية عديدة بالمنطقة الواقعة شرقي مدينة الجزيرة، في غياب سيادة الخلافة العباسية وتدهور السلطة البويهية ببلادهم الجبلية الوعرة والنائية ،حتى صارت لهم بمرور الوقت إمارة كانت في وقت لاحق – العهد المغولي والتركماني – إحدى إمارات كردستان، على إننا نجهل تماماً كيف قامت هذه الإمارة ومن هو الأمير المؤسس وفي أية سنة كان ذلك، غير إن بإمكان حصر الحقبة التي ظهرت فيها الإمارة بين سنتي (380– 420هـ/990–1029م)، وهي الحقبة التي شهدت ظهور ونمو إمارات وزعامات واتحادات قبلية عديدة بمختلف انحاء كردستان، ويمكن تقسم تاريخ الإمارة البُختية – البوتانية إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تأريخها في العصر العباسي.
المرحلة الثانية: تأريخها في عهود السيطرة المغولية والتركية والتركمانية.
المرحلة الثالثة: تأريخها في العصر العثماني.
-ممتلكات الإمارة في العصر العباسي:
في هذه المرحلة كانت الإمارة شبه مجهولة وبقيت صغيرة ومحدودة النفوذ والسلطة قياساً إلى الإمارات الكُردية الكبيرة مثل الإمارة الدوستكية- المروانية والشدادية والروادية وغيرها، وفي الحقيقة ان الولاة والحكام العسكريون والاتابكة الذين تولوا السلطة بالموصل من جهة، وأمراء الإمارة المروانية من جهة أخرى لم يفسحوا المجال إمام أمراء البُختية لتوسيع رقعة إمارتهم غرباً، فلم تصل حدود الإمارة إلى مركز مدينة الجزيرة (بوتان) الواقعة على الطريق التجاري والعسكري الذي يربط الموصل بمدن الجزيرة الشمالية، وكانت الجزيرة خلال القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي خاضعة لسيطرة الإمارة المروانية ونصب الأمير نصر الدولة أحمد بن مروان الكُردي (401–453هـ/1010 –1061م) ابنه أبا حرب سليمان نائباً له على المدنية([10]) .
وبعد سقوط الإمارة المروانية سنة 478هـ/1085م اصبحت السيادة على الجزيرة بيد حكام واتابكة الموصل، فكانوا يقطعونها لمن ينال رضاهم من أولادهم وأتباعهم ([11])، واقتصرت سلطة وسيادة أمراء البُختية على القلاع والحصون المنيعة الواقعة إلى الشرق من الجزيرة والتابعة لها، وإلى الجنوب من بحيرة أخلاط (بحيرة وان)، وعرفت هذه المنطقة الجبلية بالزوزان([12])، والزوزان في اللغة الكُردية تعني المناطق الباردة التي تتخذها القبائل الكُردية مصائف لها لرعي مواشيها، وصارت تسمية جغرافية منذ عهد الفتوحات الإسلامية([13])، وكانت كورة (مقاطعة) الزوزان خلال العصر العباسي تشمل كل المناطق الجبلية الواقعة بين الموصل وبلاد هكاري من الجنوب ومدينة أخلاط من الشمال وآذربيجان من الشرق وديار بكر والجزيرة من الغرب، ويقول ياقوت: «الزوزان كورة حسنة بين خلاط وبين جبال أرمينيا وآذربيجان ودياربكر والموصل وأهلها الأرمن وفيها طوائف الأكراد… وأول حدوده من نحو يومين من الموصل إلى أول حدود خلاط وينتهي حدها إلى أول عمل سلماس» ([14]) .
وانتشرت في إنحاء الزوزان معاقل وقلاع وحصون كثيرة معظمها كانت للكرد البُختية والبشنوية، وكانوا يحتفظون بسلطانهم المطلق في معاقلهم الجبلية البعيدة المنال حتى بعد معركة جالديران سنة 920هـ/1514م([15]). ومن هذه القلاع: حزدقيل (طورطيل) وآتيل وعلوس وباز الحمراء (بأزاء الحراء) وبرخو وبشير وألقي وأروخ وباخوخه وكنكور ونيروه وخوشاب، والقلاع الأربع الأولى كانت لأمراء البُختية، وقد احتل بدر الدين لؤلؤ اتابك الموصل (615–657هـ/ 1218–1259م) غالبية هذه القلاع وضمها إلى أملاكه([16]) .
وكانت حزدقيل أجل قلعة للبختية والمركز الرئيسي للإمارة، فوصفت بأنها «كرسي مملكة الأكراد البُختية»([17])، وهي على المقربة من جبل الجودي الشهير، وضمت إعمالها حوالي مئة قرية عامرة للأرمن والمسلمين، ووجدت بها مشاتي ومرابع القبائل الكُردية المسلمة واليزيدية([18]) .
أمراء البُختية (الجيل الأول):
1- الأمير موسك بن المجلي (؟ – 447هـ/ 1055م):
لا يقدم ابن الأثير وغيره من المؤرخين المسلمين شيئاً عن أمراء البُختية الأوائل، فلا نعلم شيئاً عنهم حتى اسمهم باستثناء الأمير موسك بن المجلي الذي ورد ذكره في سياق الحديث عن مقتل سليمان بن نصر الدولة نائب الجزيرة سنة 447هـ/ 1055م.
وتفاصيل القصة هي ان نصر الدولة المرواني قد عين ابنه سليمان نائباً له على الجزيرة كما مر بنا، فاستبد بالأمر واستولى على أراض وأملاك تابعة للأمير موسك، فحصلت بينهما منافرة، والظاهر ان سليمان كان عاجزاً على التخلص من الأمير البختي بسبل عسكرية، فلجأ إلى عمل حيلة وأقترح عليه ان يتزوج كريمة الأمير أبي طاهر البشنوي صاحب قلعة فَنَك وهو ابن أخت نصر الدولة أحمد والد سليمان، فوافق الأمير موسك وتصالح معه وعمل باقتراحه ووفد عليه بالجزيرة، فغدر به سليمان والقي القبض عليه وأودعه في السجن، وفي هذه الإثناء كان السلطان طغرل بك السلجوقي (429 – 455 هـ/1038 – 1063م) يواصل حملاته على أقاليم الدولة العباسية ووصل إلى إقليم الجزيرة، فتدخل في الأمر وأرسل إلى نصر الدولة المرواني من يشفع في موسك، فأجابه نصر الدولة بأن الأمير موسك توفي بالسجن، ولما علم أبوطاهر البشنوي بوفاة صهره تأسف كثيراً وكتب إلى نصر الدولة وابنه سليمان قائلاً لهما «حيث أردتما قتله فلم جعلتما ابنتي طريقاً إلى ذلك» ([19]) .
2- الأميران أسد الدين البُختي وحسام الدين عزيز البُختي:
لا يعلم مَن تولى رئاسة البُختية بعد مقتل الأمير موسك وصار أميراً، ولم نعثر على اسم أميرٍ آخر، ومع ذلك يمكن القول ان الإمارة البُختية ظلت قائمة بقلاع الزوزان كما أكد ياقوت الحموي في أكثر من مناسبة([20])، ويشير ابن شداد إلى أميرين بُختيين هما أسدالدين البختي وحسام الدين عزيز البختي الذان شهد عهدهما الاحتلال المغولي لكردستان وكان الأمير أسد الدين من أمراء الملك السعيد نجم الدين بن ايلغازي الارتقي صاحب ماردين([21]) .
وفي شهر رمضان عام 659هـ/1261م وفد الملك المظفر قره أرسلان بن الملك السعيد الأرتقي على هولاكو بأعمال سلماس، مُستصحباً معه جماعة من الأمراء ومحملاً إليه هدايا وتحف ثمينة من مدخرات أبيه وجدوده، غير أن ذلك لم يقنع هولاكو، واتهم الملك الأرتقي بأنه اتصل سراً بالمماليك حكام مصر، وأمر بضرب رقاب جمع من أمرائه وأصحابه وكانوا نحو سبعين شخصاً، ومن بينهم عدداً من الأمراء الكُرد، كأسد الدين البُختي وحسام الدين عزيز البُختي وأيوب المهراني([22]).
ويعزي قرطاي الخزنداري (ت بعد 708هـ/1308م) سبب نقمة هولاكو على هؤلاء الأمراء، إلى رفضهم تسليم مدينة ماردين ولتصديهم للمغول حين داهموا المدينة([23]).
وفي الواقع إن عساكر المغول الحقوا أضراراً جسيمة بمدينة الجزيرة والقبيلة البُختية وأسقطوا إمارتها، وفَرّ من نجا من رجال البُختية إلى بلاد الشام ومصر وتفرقوا في البلدان، ويقول ابن العبري بهذا الصدد ان سيف الدين صاحب الجزيرة اجتمع إليه سبعين ألف كردي وأمضوا به إلى سورية([24])، ويضيف العمري «والبُختية وهم قوم كانوا يضاهون الحميدية، لكنهم شُعبهم أكثر وقبيلهم أكبر، لهم كبراء وأعيان وأمراء، فهلك أمراؤهم وتشتت كبراءهم وتفرق جمعهم المعهود ولم يبق منهم إلا شرذمة قليلة تفرقت بين القبائل والشعوب» ([25]).
وقد وصلت جماعات متفرقة من رجال قبيلة البُختية الفارون إمام المغول إلى بلاد الشام ومصر، وانضموا إلى صفوف الجيش المَملوكي، وجاء في وصية (مقدم الأكراد) المقيمون في ديار الدولة المملوكية: «وليعلم ان صدقاتنا العميمة غير قليلة وان رعايتنا الشريفة ستعمهم – أي الكُرد- وتوقد نار كل قبيلة وأننا لا ينقص عندنا بخت بُختي (البُختية) ولا ننسى طرف ديسني (الداسنية)..» ([26]) .
إعادة تأسيس الإمارة بالجزيرة:
لم تمض إلا سنوات قليلة حتى أعادت قبيلة البُختية تأسيس إمارتها من جديد وسيطرت على قلاعها وحصونها، وأخضعت مدينة الجزيرة نفسها.
وجزيرة ابن عمر- بوهتان مدينة كردية تسميةً وتاريخاً وانتماءً، فاسمها القديم كان قردو وهو نفس اسم كردو وأطلقت عليها السريان والطوائف المسيحية الأخرى منذ عصور ما قبل الإسلام وحتى العهود الإسلامية المبكرة اسم باقردى أو باقردو وهو تخفيف بيث قردو أي بيت الكُرد – بلاد الكُرد، ويقول ياقوت الحموي ان أهل باقردي يسمون مدينتهم قردى ([27])، وكانت تقابلها على دجلة مدينة أخرى هي بازبدى – قرية بازفتى الحالية على الحدود السورية التركية – وأحيانا يأتي اسم المدينتين معاً وجاء في بيت شعر:
بقردي وبازبدى مصيف ومربع وعذب يحاكي السلسبيل برود([28]).
وإلى جانب تسمية باقردى، عرفت بوهتان حتى عهد الخليفة المأمون العباسي (198- 218هـ/ 814 – 833م) أو حتى سنة 250هـ/ 864م في رواية أخرى بـ «جزيرة الأكراد» وهو الترجمة العربية لجزرتا دوقردو دون شك، لأن الأكراد، كما يقول ابن شداد: «كثيراً ما ينتابونها وينتجعونها لقضاء أوتارهم» ([29]).
وفي تلك الآونة -القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي-، نزل بجزيرة الأكراد إي بوهتان رجل أختلف رواة الأخبار فيه، فقالوا هو الحسن بن عمر التغلبي في رواية وقالوا أوس وكامل ابني أوس التغلبي أو ابني يوسف بن عمر التغلبي في روايات أخرى([30]) .
ويقول ابن خلكان (ت681هـ/1282م): «ولا أدري من أبن عمر… ثم اني ظفرت بالصواب في ذلك وهو ان رجلا من أهل برقعيد من أعمال الموصل بناها وهو عبد العزيز بن عمر البرقعيدي، فأضيف أليه» ([31])، ولم يكن البدليسي على الصواب حين نسب بناء قلعة الجزيرة إلى الخليفة الأموي الثاني عمر بن عبد العزيز([32]) .
وقد قام هذا الرجل (ابن عمر) بتخطيط المدينة وإعمارها، فعرفت منذ ذلك الحين بجزيرة ابن عمر وطغى الاسم الجديد على الأسماء القديمة للمدينة.
وتمتعت مدينة الجزيرة بموقع جغرافي مهم، فهي تقع على الطريق الذي يربط الموصل بمدن شمال اقليم الجزيرة كما ذكرنا، كما إن وقوعها على دجلة أضفى عليها أهمية اقتصادية إضافية، فوجد بها رستاق خصب واسع الخيرات وكانت هناك داخل المدينة حوالي ثلاثين بستاناً([33])، واشتهرت بإنتاج وتصدير الجبن والعسل رغم ما أصابها من الخراب والدمار اثر استيلاء المغول عليها([34]).
وكانت تتبع الجزيرة ثمان قلاع خلال القرنين السابع والثامن للهجرة/الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، عندما قامت بها الإمارة البُختية وهذه القلاع هي:
الجراحية، قلعة فرح، برخو، فنك، الجديدة، القصر، أروخ، كنكور([35])، هذا بالإضافة إلى حوالي مئة قرية عامرة ([36]).
ومن أهم قرى الجزيرة، القريشية التي اشتهرت بإنتاج التفاح القريشي([37]) وقرية العقيمة التي تحاذي الجزيرة بينهما نهر دجلة ووجدت بها بساتين كثيرة ([38]) .
والجدير بالملاحظة من تاريخ الإمارة البُختية (إمارة الجزيرة) خلال عهود الاحتلال المغولي والتركي والتركماني (المرحلة الثانية)، أنها توسعت كثيراً وغدت إحدى إمارات كردستان الكبيرة، فاشتملت مناطق نفوذها فضلاً عن الجزيرة العاصمة على أكثر من أربع عشرة قلعة وناحية أهمها: كوركيل وإعمالها، قلعة أروخ وهي من أمنع قلاع كردستان، ناحية طنـزي وقلعتها، قلعة فَنَك وناحيتها، ناحية الهيثم، ناحية شاخ وقلعتها وغيرها، كما التف رجال القبائل الكُردية: شهريوري، استوري، أروخي، كارسي، جلكي، شيلدي، شيخ بزيني، رشكي، ماسكي، شيرواني، دنبلي، محمودي، براسي- برازي وغيرها حول أمير الجزيرة وشكلت جميعها التحالف القبلي البُختي([39]) .
وقد عمل السلطان المملوكي بمصر ونائبه على بلاد الشام على فتح باب العلاقات مع الإمارة البُختية لما لها من الفائدة للجانبين.
أمراء الجزيرة (الجيل الثاني):
1- الأمير سليمان بن خالد وابنه الأمير عبد العزيز:
يذكر البدليسي بأن أول من تولى الحكم في الجزيرة خلال العهد المغولي هو سليمان بن خالد، دون ان يقدم شيئاً عن إخباره ولا يحدد تاريخ توليه الحكم، وربطت الحكايات والقصص الشعبية نسب سليمان بن خالد بالصحابي خالد بن الوليد، ولا شك ان هذا الادعاء لم ينشأ الا من ولع الكُرد بالبطولة واعجابهم ببسالة خالد بن الوليد، لا سيما وان خالد بن الوليد لم يكن له عقب([40]) .
ويعد وفاة سليمان، تقاسم أبناءه الثلاثة: عبد العزيز والحاج بدر وأبدال تركة أبيهم فيما بينهم، وكانت الجزيرة القاعدة من نصيب الأمير عبد العزيز لكونه أرشد الأولاد كفاية وأكثرهم استعداداً ومقدرة للقيام بمهام الحكومة، وتولى الحاج بدر الحكم بقلعة كوركيل، وتولى الأمير ابدال الحكم بقلعة فنك([41]) .
ويعد الأمير عبد العزيز المؤسس الثاني للإمارة البُختية (إمارة الجزيرة) بعد سقوطها على يد هولاكو، وهو الجد الأعلى لأمرائها فعرفت الأسرة الحاكمة بـ (ئازيزان – العزيزان) نسبة إليه([42]) ولا توجد في المصادر المملوكية أية معلومات تخص الأمير عبد العزيز وأخويه، وأعتقد إن عبد العزيز المذكور في شرفنامه ما هو إلا الأمير حسام الدين عزيز الذي قتل بأمر من هولاكو.
2- الأمير عزالدين أحمد بن سيف الدين البختي (؟- 764هـ/1362م):
من الثابت تاريخياً ان أمير الجزيرة في بداية العهد التركي الجلائري(737-814هـ/1336-1411م) هو الأمير عزالدين أحمد بن سيف الدين البختي([43])، وسيف الدين في شرفنامه([44]) هو الابن الأكبر لعبدالعزيز بن سليمان.
ارتبط الأمير عزالدين بعلاقات حميمة مع الدولة المملوكية بمصر، وكان السلطان المملوكي يقدره ويعترف به بأنه «الحاكم بجزيرة ابن عمر»، وكان يتبادل معه مخاطبات ومكاتبات رسمية، فالرسائل كانت تأتيه من مصر من الدرجة السابعة المعبر عنها في دواوين الإنشاء بـ «صدرت والسامي» ([45]).
3-الأمير سيف الدين عيسى بن عزالدين (764 – 785هـ/ 1362 – 1383م):
توفي الأمير عزالدين سنة 764هـ/ 1362م وخلفه في السلطة ابنه الأمير عيسى، فأخبر السلطات المصرية بأن والده توفي وانه حل محله وأستقر بمكانه([46])، ويقول البدليسي ان الأمير عيسى هو ابن مجدالدين بن عبد العزيز، ويخالف بذلك كاتب الإنشاء والمؤرخ المملوكي ابن ناظر الجيش (ت 786هـ/1384م) المعاصر للإحداث، الذي يؤكد ان كتاب الأمير عيسى وصل في شهر صفر يخبر فيه بوفاة والده عزالدين أحمد([47]) .
لا يورد البدليسي والمؤرخون المصريون شيئاً عن الأمير عيسى بعد توليه السلطة، وهناك نص يفيد بان صاحب الجزيرة في سنة 783هـ/1381م هو الأمير سيف الدين، ونص آخر حول وفاة الأمير سيف الدين في شهر رجب سنة 785هـ/ 1383م([48]).
وأعتقد ان الأمير سيف الدين هو الأمير عيسى بن الأمير عزالدين أحمد بن الأمير سيف الدين نفسه، ويظهر انه تلقب كجده بلقب سيف الدين، وهو أمر مألوف بين الأمراء الكُرد ان يتلقب أحدهم بلقب جده.
4- الأمير أبدال -عبد الله (785هـ/1383م -؟):
لا يتفق البدليسي مع المؤرخ المصري المعروف ابن حجر العسقلاني في تحديد اسم وهوية الشخص الذي خلف الأمير سيف الدين عيسى، فالأول يذكر ان ابنه وثمرة فؤاده بدرالدين هو الذي خلف أبيه، ويقدم عنه معلومات عامة تنطبق على كل أمير عادل تجاه رعاياه، وبعد وفاته تولى ابنه الأمير أبدال حكم الإمارة ([49])، وإذا صح ذلك فيصبح الأمير ابدال حفيداً للأمير سيف الدين عيسى، بينما يذكر أبن حجر في رواية غير واضحة، انه بعد وفاة سيف الدين تولى أخوه عزالدين أحمد و ابنه عبدالله وشخص ثالث يدعي علي طيره السلطة مكانه، ثم توفي علي طيرة قبل ولده أبي بكر (؟)، ويؤكد في موضع آخر ان «كبير البُختية» في عام 787هـ/ 1385م هو عبدالله البُختي ([50]) .
5- الأمير عز الدين البختي المعاصر للغزوات التيمورية لكردستان:
يروي البدليسي ان الأمير عزالدين هو ابن الأمير ابدال وقام مقام أبيه في الإمارة([51])، ولكن لا يستبعد ان يكون هو عم الأمير عبدال الذي أشار إليه ابن حجر عند وفاة الأمير سيف الدين سنة 785هـ/1383م، ولا ندري متى صار أميراً على الجزيرة.
والحدث الأهم في عهد الأمير عز الدين هو تعرض بلاد الجزيرة وسار إنحاء كردستان للغزوات التيمورية.
في شتاء سنة 796هـ/ 1394م وصل تيمور للمرة الثانية إلى إقليم ديار بكر عن طريق بغداد – تكريت – كركوك – أربيل – الموصل مخلفاً وراءه الخراب والدمار، وقبل ان تشارف طلائع قواته على بلد الجزيرة، تقدم إليه الأمير عز الدين وامتثل بين يديه معلناً طاعته وولاءه له، وقدم له هدايا ثمينة وتعهد بإرسال الأقوات والأموال لتمويل جيشه، فأقره تيمور على بلاده وسمح له بالرجوع إلى مقر حكمه، غير ان شيخ البختي أحد رجال البُختية لم يرجع مع الأمير عز الدين إلى الجزيرة وبقي بجانب تيمور ([52]).
وكان من عادة تيمور أخذ أموال طائلة من الأمراء والحكام الذين يطيعونه، وذلك من الهدايا والنقود والتحف والنوادر والطقوزات (الهدايا التسع) وغيرها ، فتجمع لديه كمية كبيرة منها ،وكان ينوي نقلها إلى أهله وأولاده بمدينة السلطانية بآذربيجان، وعند ذلك انتهز شيخ البُختي الفرصة وأستأذن من تيمور الرجوع إلى الجزيرة، وكان ينوي نهب أموال تيمور عند مرور القافلة بالجزيرة واسترجاع التحف والهدايا التي قدمها الأمير عزالدين لتيمور رغماً عنه، ولما وصلت قوافل الهدايا والغنائم قبال الجزيرة، نهبها شيخ البُختي ورجاله نهباً تاماً وفروا إلى قلعة الجزيرة واحتموا بها، وحين علم تيمور بالخبر، طلب من الأمير عزالدين مرتين بتسليم شيخ البُختي وإلا فسوف يقوم باكتساح جميع ولاية الجزيرة بقلاعها وقبائلها، إلا ان الأمير عزالدين رفض طلب تيمور وتحصن بالقلعة استعداداً لمواجهة رد فعل تيمور معتمداً على حصانة القلعة ومياه نهر دجلة([53]) .
وفي شهر جمادي الأول عام 796هـ/ آذار 1394م عبر تيمور نهر دجلة بكامل جيوشه وهاجم الجزيرة واحتل المدينة وأباحها للسلب والغنيمة، وتم إخضاع معظم القلاع التابعة للجزيرة، وتعرضت للسلب والنهب والاغتنام، حيث غنم العساكر التيمورية مالا تعد ولا تحصى من الأغنام والمواشي والخيول وحيوانات الحمل([54]).
وشاعت بين أهل الجزيرة، رواية غير التي سجلتها المصادر التيمورية حول سبب قيام تيمور باحتلال مدينتهم وما آل إليه مصير الأمير عزالدين، ومفادها ان الأمير عزالدين أخفي نفسه عن أنظار تيمور وحل بين رجال قبيلة أروخي – صاحبة قلعة أروخ وقضي بينهم بقية حياته في تعاسة وشقاء ([55]).
وفي الحقيقة ان الأمير عزالدين على الرغم من تلقيه ضربة موجعة على يد التيمورية، بقي بخلاف ماجاء في شرفنامه أميراً إلى ما بعد سنة 817هـ/ 1414م، واحتفظت الإمارة بسيادتها واستقلالها، لاسيما بعد ان توفي تيمور سنة 807هـ/ 1404م وأحتدم الصراع بين أولاده وأحفاده.
ففي سنة 817هـ/ 1414م، استجاب كل من الأمير عزالدين البختي والأمير توكل الكُردي صاحب شرانش والأمير محمد الحزدقيلي صاحب قلعة حزدقيل، لطلب الفقيه الشافعي المتعصب جلال الدين محمد بن عزالدين الحلواني لقتال اليزيدية وإبادتهم، فسار الجميع نحو لالش وقتلوا وأسروا الكثير من الكُرد اليزيدية وهدموا القبة ونبشوا ضريح الشيخ عدي بن مسافر الهكاري شيخ اليزيدية واخرجوا عظامه وأحرقوها أمام أعين من أسروه من اليزيدية([56]) .
وموقف الأمير عزالدين البختي من الكُرد اليزيدية، يوضح ان أمراء الجزيرة تخلوا عن الديانة اليزيدية وأعتنقوا الإسلام قبل عهد الأمير عزالدين بوقت غير قصير، حيث كانت الاسرة الحاكمة من البُختية فيما مضى على الديانة اليزيدية وقد بقي عدد من قبائل ناحية كوركيل التابعة لأمراء الجزيرة على اليزيدية حتى العهد العثماني([57]) .
وقبل هذا التاريخ -سنة 808هـ/ 1405م – التحق أمير الجزيرة مع غيره من الأمراء والزعماء الكُرد بقره يوسف القره قوينلو عندما رجع من بلاد الشام، وهذا يعني ان الإمارة رغم حملات تيمور المتواصلة، بقيت على حالها ولم تؤد هذه الحملات إلى إسقاطها نهائياً، كما بقي الأمير عزالدين على قيد الحياة ومارس الحكم بالجزيرة بعد الغزو التيموري بأكثر من عشرين سنة ([58]).
سار الأمير عزالدين على نهج آبائه وسياستهم تجاه الدولة المملوكية بمصر وهي اكبر دولة إسلامية آنذاك، وحافظ على علاقاته الحسنة مع السلطان المملوكي ونائبه على بلاد الشام، حيث أن كلا من الدولة المملوكية والإمارات الكُردية كلها، كانت بحاجة إلى توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتوحيد الجهود ورص الصفوف لصد حملات تيمور لنك العنيفة وافشال مساعيها التوسعية بالمنطقة، وكانت المكاتبات والرسائل تأتي إلى أمير الجزيرة من نائب بلاد الشام المملوكي من المرتبة السادسة المعبر عنها في دواوين الإنشاء بـ «الجناب العالي» ([59]).
لا تخبرنا المصادر بنهاية الأمير عزالدين، ويذكر القزويني ان أسكندر بن قره يوسف القره قوينلو أجتاح آذربيجان سنة 828هـ/1425م وقتل عزالدين ملك الكُرد ([60])، ومن المستبعد ان يكون الأمير المقتول هو عزالدين البختي والأرجح هو الأمير عزالدين شير الهكاري «ملك كردستان» الذي كان سلطانه يمتد الى آذربيجان.
6- الأمير مجدالدين (تولى الحكم في حدود سنة 820 هـ/ 1417م):
تتعارض معلومات البدليسي حول أمراء الجزيرة وتسلسلهم مع المعلومات القليلة المبعثرة في المصادر الفارسية والمملوكية، فيقول بعد وفاة الأمير عزالدين اعتلى ابنه الأمير عبدال – ابدال السلطة بالجزيرة وتولى رئاسة القبائل والعشائر، غير انه لم ينعم بالسلطة طويلاً فوافاه الأجل في وقت مبكر، فتسلم ابنه الأمير إبراهيم الحكم، فتوفي ولم يطيل عهده زمناً يذكر، مخلفاً ثلاثة أولاد الأمير شرف والأمير بدر وكاك محمد، فحل الأول محل والده وصار أمير الجزيرة إلى أن أدركته المنية بعد أن حكم كجده وأبيه لمدة قصيرة([61]) ولا يذكر أميراً بأسم مجدالدين.
في حين يظهر بوضوح من حديث أبي بكر الطهراني ان أمير أو حاكم الجزيرة في حدود سنة 825هـ/1422م هو الأمير مجد الدين، وكان أميراً قوياً وصاحب جيش نظامي كبير، بحيث لما استنجد به اسكندر بن قره يوسف، التحق به ومعه ثلاثة آلاف رجل ([62]).
ولا يعلم صلة القرابة بين الأمير مجد الدين والأمراء الذين ذكرهم البدليسي.
7- الأمير أبدال – عبد الله الثاني (قبل841 هـ/ 1437م):
بينّا ان الأمير ابدال حسب قول البدليسي لم يحكم طويلاً وتوفى، غير ان المصادر الفارسية تذكر ان ابدال بيك حاكم الجزيرة وملك خلف الأيوبي أمير حصنكيفا وقفا سنة 841هـ/1437م بجانب سلطان حمزة بن قره ايلك عثمان الآق قوينلو لمواجهة أصفهان بن قره يوسف القره قوينلو([63]) .
وهذا ربما يعني ان الأمير ابدال بخلاف حديث البدليسي بقي أميرا على الجزيرة حتى السنة المذكورة، أو يحتمل ان يكون الأمير ابدال بيك هذا غير الأمير ابدال ابن الأمير عزالدين ويجوز ان يكون ابن الأمير مجد الدين.
ويخالف ابن تغري بردي الطهراني وحسن روملو، ويقول ان صاحب الجزيرة خلال عهد السلطان المملوكي الملك العزيز يوسف (13 ذي الحجة 841 هـ-19 ربيع الأول 842هـ) هو الأمير عمر البختي ([64]).
وبالامكان ترجيح رواية الطهراني، فهو أقرب الى موقع الأحداث ومؤرخ بلاط الآق قوينلو، كما يؤكد المؤرخ السرياني أدي السبريني وهو من أهل ديار بكر والمعاصر للأحداث ان الأمير عبد الله بقي أميراً الى مابعد سنة 859هـ/1455م ([65]).
8- الأمير بدرو (بدر) بيك (؟ – 873هـ/1469م):
يعد الأمير بدرو بيك (بدر) من أمراء الجزيرة الكبار وحكم لمدة طويلة، وكان يتمتع بسلطات واسعة وبقسط كبير من الأستقلال، حيث خطب لنفسه بالجزيرة وسك النقود بأسمه، ويقول المؤرخ المصري زين الدين عبدالباسط الحنفي (ت:920 هـ /1514م) عنه:
«بدروه الكردي الملك بجزيرة ابن عمر، هو من أعيان ملوك الاكراد بتلك البلاد وله حرمة وافره وكلمة نافذة ببلاده وله خطبة بجزيرة ابن عمر وأحوازها وضربت السكة على الدرهم باسمه وكان تولى الجزيرة عن السلطان عبد الله»([66]).
وليس مستبعداً ان يكون ابن الأمير أبدال أو ابن الأمير إبراهيم بن الأمير أبدال([67])، وشهد عهده ظهور الأمير أوزون حسن ألاق قوينلو (حسن الطويل) (857- 882هـ/1453–1478م).
وقد انتهج حسن الطويل سياسة عدوانية توسعية تجاه الإمارات والزعامات الكُردية القائمة بإقليم ديار بكر وأرمينيا السفلى، وقضى على عدد منها وأحتل جملة مواضع في إنحاء كردستان، ففي سنة 873هـ/ 1469م قاد جيشاً كبيراً وانطلق من ديار بكر وسار نحو الجزيرة وانضم إليه عدد من الأمراء والحكام بقواتهم أمثال داروغا آمد وداروغا بيرجك وحكام مدن سنجار والموصل وتلعفر ، وحاصرت قواتهم المؤلفة من خمسة آلاف فارس،مدينة الجزيرة وسيطرت عليها ثم أخضعت قلعة ساق -شاخ، ففر الأمير بدرو وتحصن بقلعة كارسي، فشد الأمراء التركمان الحصار على القلعة، فاضطر الأمير بدرو إلى تسليم القلعة لهم([68]) .
ويقول البدليسي ان هجوم حسن الطويل على الجزيرة كان في عهد الأمير كاك محمد أخ الأمير بدر، وهو خطأ منه دون شك، لأن أبابكر الطهراني كان ضمن الحملة التي شنها أوزون حسن على إمارات دياربكر وهو مؤرخ بلاط أوزون حسن وحرر كتابه سنة 875هـ/1470م أي بعد سنتين من احتلال الجزيرة.
وقد أدت حملة حسن الطويل إلى حلول الدمار والخراب ببلاد الجزيرة ولقي الكثير من وجهاء ورجال البُختية حتفهم، ووقع الأمير وإخوانه في اسر التركمان، فأبعدوا إلى العراق وألحقت بلاد الجزيرة بدولة الآق قوينلو وأناط حسن الطويل إدارة الجزيرة برجل من التركمان يدعي جلبي بك ([69]).
9- الأمير شرفخان بن الأمير بدر:
كان الأمير شرفخان من رجال البُختية الذين نجوا من قبضة حسن الطويل، حيث فر من الجزيرة واختفى في زاوية نائية وقضى حياته متنكراً، وكان يتحين الفرص لإعادة السيطرة على الجزيرة وطرد تركمان الآق قوينلو منها.
ومنذ سنة 897هـ/1492م أخذ الضعف والانحلال يدب في اوصال دولة الآق قوينلو وعمت الفوضى والاضطرابات إرجاء الدولة، واشتدت المنافسة والصراع بين أمراء الآق قوينلو، هذا في الوقت الذي كان النفوذ الروحي والسياسي للصفويين يزداد بين الناس يوماً بعد يوم، وكانت هذه الأوضاع فرصة مناسبة للأمير شرفخان لإعادة أمجاد آبائه بعد حوالي ثلاثين سنة من الانتظار والترقب، ونجح فعلاً في استرجاع الجزيرة وسائر قلاع وحصون البُختية وتولى حكمها وإدارتها([70]) .
=====================
[1] – دائرة المعارف الاسلامية، مادة بوهتان، 4/250.
[2]– كتاب دياربكرية، ص542.
[3]– سترك، مادة بهتان، 4/251، محمد أمين زكي، كورد وكوردستان، 1/40.
[4]– شرفنامه، ص320.
[5]– ابن عساكر، تأريخ دمشق،40/63.
[6]– شرفنامه، ص270-271.
[7]– المصدر نفسه، ص273-274.
[8]– الذهبي، ذيل تأريخ الإسلام، ص200، ذيول العبر، ص26،23، الدرر الكامنة، 2/97، الدارس في تأريخ المدارس، 1/304-305، 376-377.
[9]– معجم البلدان، 3/ 158.
[10]– الكامل، 8/69.
[11]– ينظر: ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، 3/217-245.
[12]– معجم البلدان، 3/158، الأعلاق الخطيرة، 3/230، ابن العبري، تأريخ الزمان، ص206، 254، 260.
[13]– البلاذري، فتوح البلدان، ص 180.
[14]– معجم البلدان، 3/158.
[15]– شترك، مادة بهتان، 4/252.
[16]– معجم البلدان، 3/158، تأريخ الزمان، ص260–261.
[17]– معجم البلدان، 2/ 124، 3/158.
[18]– شرفنامه، ص273.
[19]– الكامل، 8/69-70.
[20]– معجم البلدان، 1/51، 321، 3/ 158، 4/147.
[21]– الأعلاق الخطيرة، 3/564، 570.
[22]– المصدر نفسه، 3/570، قرطاي الخزنداري، تأريخ مجموع النوادر، 1/196، الدواداري، الدرة الزكية، ص84.
[23]– تأريخ مجموع النوادر، ص196.
[24]– تأريخ الزمان، ص 321.
[25]– مسالك الإبصار، 3/134، صبح الأعشى، 4/378.
[26]– التعريف بالمصطلح الشريف، ص149.
[27]– معجم البلدان، 1/327.
[28]– تاريخ الطبري، 4/625.
[29]– الأعلاق الخطيرة، 3/7.
[30]– معجم البلدان، 2/ 138، ابن خلكان، وفيات الاعيان، 3/350، الأعلاق الخطيرة، 3/213، لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص123.
[31]– وفيات الاعيان، 3/349.
[32]– شرفنامه، ص270.
[33]– معجم البلدان، 2/138، الأعلاق الخطيرة، 3/215.
[34]– صورة الأرض، ص202، نزهة القلوب، ص157، بلدان الخلافة الشرقية، ص123.
[35]– الأعلاق الخطيرة، 3/215.
[36]– نزهة القلوب، ص157.
[37]– معجم البلدان، 4/337.
[38]– الكامل، 9/107، الأعلاق الخطيرة، 3/224.
[39]– شرفنامه، ص273-274.
[40]– شرفنامه، ص269، وهامش رقم (1).
[41]– المصدر نفسه، ص274-275.
[42]– المصدر نفسه، ص275.
[43]– ابن ناظرالجيش، تثقيف التعريف، ص77، صبح الأعشى، 7/297.
[44]– شرفنامه، ص275.
[45]– تثقيف التعريف، ص77، صبح الأعشى، 7/297.
[46]– صبح الأعشى، 7/297.
[47]– تثقيف التعريف، ص 77، صبح الاعشى، 7/297.
[48]– ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، 1/239، 280.
[49]– شرفنامه، ص276-277.
[50]– انباء الغُمر،1/ 280، 303.
[51]– شرفنامه، ص277.
[52]– شامى، ظفرنامه، ص149-150، يزدى، ظفرنامه، 1/478-479، الغياثي، التأريخ الغياثي، ص190.
[53]– ظفرنامه يزدى، 1/478، شرفنامه، 277-278.
[54]– ظفرنامه شامى، ص150، ظفرنامه يزدى، 1/479، شرفنامه، ص278.
[55]– ينظر تفاصيل القصة: شرفنامه، ص278.
[56]– السلوك، 4/1/293 – 294.
[57]– شرفنامه، ص273.
[58]– كتاب دياربكريه، ص 57.
[59]– صبح الأعشى، 8/226.
[60]– لب التواريخ، ص214.
[61]– شرفنامه، ص279.
[62]– كتاب دياربكريه، ص 78 – 79.
[63]– المصدر نفسه، ص 131، حسن روملو، أحسن التواريخ، 1/231.
[64]– النجوم الزاهرة، 15/224.
[65]– مار أغناطيوس، تأريخ طورعابدين، ص104-106.
[66]– المجمع المفنن بالمعجم المعنون، 2/183.
[67]– شرفنامه، ص282.
[68]– كتاب دياربكريه، ص 542 – 543.
[69]– كتاب ديار بكريه ص542، شرفنامه، ص279.
[70]– شرفنامه، ص279-281.